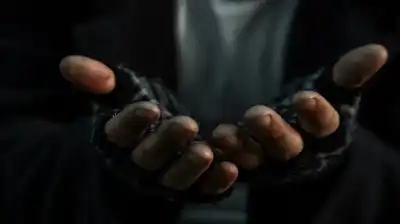مدار الساعة - دعت ورقة تقدير موقف صادرة عن معهد السياسة والمجتمع بعنوان “ما بين الضم وإعلان الدولة: نقطة تحوّل تاريخي فلسطيني أردني” إلى ضرورة التنبه لمخاطر السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يرافقها من تسارع في وتيرة الاستيطان وفرض السيادة الفعلية على الأرض، إضافة إلى تداعيات ذلك على السلطة الفلسطينية ومستقبل الاستقرار في المنطقة.
وأشارت الورقة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالضم الزاحف، مصادرة الأراضي والمياه، وهدم التجمعات الفلسطينية، قد بلغت مستويات غير مسبوقة خلال عام 2024، الأمر الذي يضع الفلسطينيين أمام خيارات صعبة ويهدد بانهيار السلطة وفقدانها للشرعية.وحذرت الورقة من أن هذه التطورات تشكل تهديدًا استراتيجيًا للأردن، سواء من حيث الضغوط الديموغرافية أو الاقتصادية أو الأمنية، معتبرة أن أي ضم محتمل سيقلب الحسابات الاستراتيجية رأسًا على عقب، ويضع معاهدة السلام الأردنية–الإسرائيلية على المحك.كما تناولت الورقة الدوافع الاستراتيجية الإسرائيلية، التي تجمع بين اعتبارات أمنية وأيديولوجية وسياسية داخلية، مدعومة بغطاء دولي، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعزز فرضية “حل الدولة الواحدة” وفق المنظور الإسرائيلي.واستعرضت الورقة أربعة سيناريوهات مستقبلية محتملة: استمرار الضم التدريجي، تجميد المسار بفعل ضغوط دولية، انفجار أمني داخلي، أو التوصل إلى حل سياسي إقليمي متدرج، مؤكدة في ختامها على حزمة توصيات استراتيجية على المستويات الفلسطيني والأردني والدولي، بما في ذلك تعزيز التنسيق الأردني–الفلسطيني ورفع الكلفة الدبلوماسية والقانونية على إسرائيل.يُذكر أن هذه الورقة جاءت كجزء من جلسة مغلقة عقدها المعهد الأسبوع الماضي حملت نفس العنوان، بمشاركة خبراء وباحثين أردنيين وفلسطينيين.ورقة تقدير موقفما بين الضم وإعلان الدولة: نقطة تحوّل تاريخي فلسطينيتتناول هذه الورقة أبعادًا متعددة للتطورات الراهنة في الضفة الغربية في ظلّ الحرب على غزة وسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفّة. من الناحية الإسرائيلية، ثَبُت أن جبهتي السياسة الأميركية والإسرائيلية اليمينية “المسيحية” تعملان بتناغم شبه كامل، ودَعَت المواقف الرسمية في واشنطن (مُمثلة بسفراء ووزراء) إلى تبني سردية دينية صلبة مماثلة للمتطرّفين الإسرائيليين. وقد أطلق المسؤولون الإسرائيليون إشارات بأنهم لن يلتزموا بمؤسّسات السلام التقليدية: بدءًا من إعلانهم عدم الرغبة في دولة فلسطينية أو وحدة بين الضفة وغزة، ووصولًا إلى قطع العلاقات مع كلّ الأطر الفلسطينية، مع التركيز على تعزيز السيطرة الميدانية عبر توسيع الاستيطان وفرض السيادة عمليًا على الأرض. في الضفة الغربية، يُلاحَظ تسارع في بناء المستوطنات: إذ شُيّدت خلال سنوات قليلة وحدها مساحات تفوق ما أُنشئ منذ عام 1967، إذ تشير المعطيات التفصيلية إلى حجم السيطرة الإسرائيلية المتزايد في الضفة. فقد وصلت أعمال البناء الاستيطاني إلى مستويات تاريخية: ففي عام 2024 أُقرّ بناء 28,872 وحدة استيطانية جديدة (18,988 منها في القدس الشرقية وحدها). وبنهاية العام نفسه بلغ عدد المستوطنين نحو 737 ألفاً (503,732 في الضفة و233,600 في القدس الشرقية)، أي ما يفوق بكثير أي تجمع سكاني فلسطيني في المناطق نفسها.أما الجوانب غير المعلنة، فتكمن في التمهيد المستمر لفرض السيادة الفعلية بصورة تدريجية. فإجراءات «فرض السيادة الصامت»، وإن لم ترتقِ إلى ضم رسمي، لكنها تخلق أمرًا واقعًا يتدرّج فيه الاحتلال من إدارة الصراع في الضفة (عصر أوسلو) إلى حسمه لصالحه. إن الضمّ الفعلي يحمّل السلطة الفلسطينية خيارين مريرين: الاستمرار بالتنسيق الأمني وفقدان بقايا الشرعية الشعبية، أو قطع التنسيق وإحداث فراغ أمني قد يؤدي إلى تفجّر عنف محلي أوسع.كما فرضت إسرائيل “سيادة كاملة” بحيث باتت كل قرية وغربتها محاطة بمستوطنات وشبكات طرق عسكرية، بينما اتخذت إجراءات (مصادرة مياه وأراضٍ وقطع رواتب العمال وقمعٍ أمني) تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وإضعاف السلطة الفلسطينية. تنتهج إسرائيل "الضم الزاحف" عبر مصادرة الأراضي والمياه، وهدم المزارع، وتدمير تجمعات بدوية، وإغلاق القرى بحجج أمنية. وقد بلغ العنف الاستيطاني مستويات غير مسبوقة، حيث سُجلت 1,420 حادثة اعتداء في 2024، أدت إلى تهجير أو إخلاء قسري لنحو 47 مجتمعاً فلسطينياً منذ أكتوبر 2023.على الجانب الفلسطيني الداخلي، جرى تسجيل تراجع حادّ في الخدمات ومؤشرات الرفاه: شهدت الضفة "انهياراً اقتصادياً متسارعاً" مع ارتفاع البطالة إلى 35% تقريباً، انخفض الإقبال على التعليم العالي نحو أقلّ مستوياته منذ عقود بسبب انشغال السكان بأمنهم المعيشي. رغم وجود توسّعات سياسية (لجان للدستور وتهيئة انتخابات المجلس الوطني ومشاريع قانون أحزاب حديثة)، بدا الحراك الفلسطيني مقيدًا بمحدوديّات السلطة القائمة. وفي المحور الأمني والاستيطاني في الضفة، برزت حقائق ميدانية خطيرة، إسرائيلياً، يتحدث القادة بصراحة عن رفضهم دولة فلسطينية. رئيس الوزراء نتنياهو أعلن أن مشاريع مثل مستوطنة E-1 تحقق وعداً "بألا تكون هناك دولة فلسطينية". فيما قدّم الوزير سموتريتش خطة لضم 82% من الضفة وترك جيوب فلسطينية معزولة، مرتكزة على مبدأ "أقصى أرض مع أقل سكان". هذه التوجهات تغلّفها أيديولوجيا دينية وقومية، وتترجم عملياً بدمج المستوطنات والطرق والمناطق العسكرية في منظومة واحدة تستبعد الفلسطينيين من أي قرار.كما عززت إسرائيل وجودها الأمني والعسكري عبر نشر كتائب وطرقات عسكرية في أرجاء الضفة، بينما وسّعت دائرة توغّل المستوطنين وأعمالهم العدائية لتصبح “روتينية” وتجتاح مئات القرى بدعم حكومي. وقد تزامن ذلك مع حملة ضغط اقتصاد-سياسي ممنهجة طالت البدو والسكان (ملاحقة رُعاة أغنام، ومصادرة مياه وأراضٍ زراعية، ومنع الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل، واحتجاز أموال السلطة). هذه الإجراءات الأمنية-الاستيطانية تدمجت مع سياسات إسرائيلية بهدف خنق صمود الفلسطينيين وإجبارهم على التسليم بتحولات حاسمة على الأرض.المحور الأردني (الموقف، مصادر التهديد، الخيارات)تطرح هذه التطورات على الأردن أخطاراً متعددة ومترابطة، فالأردن يُعاين تطورات الضفة بقلق شديد لما تشكّله من تهديد وجودي – سياسياً وديموغرافياً– على المملكة. ففي حال توسّع ضم الأغوار (أو كامل الضفة)، تنهار السلطة الفلسطينية وينهار معها الوضع السياسي الراهن، وقد ينهار معاهدة السلام الأردني في ظلّ تدفّق كبير للسكان الجديد نحو الأردن (وهو ما ينصّ بإلغاء المعاهدة في حال “تهجير قسري” من أي طرف). فمعاهدة وادي عربة (1994) ارتكزت على استقرار الضفة ووجود شريك فلسطيني. وعقيدة الأمن الأردنية ترى أن استقرار الضفة وحقوق الفلسطينيين جزء "لا يتجزأ" من الأمن الوطني، وبالتالي، يُنظر إلى الضم كتهديد استراتيجي.هناك أيضاً مخاطر أمنية: انهيار السلطة الفلسطينية أو اندلاع انتفاضة جديدة قد يؤدي إلى انتقال الفوضى عبر الحدود. ورغم قدرة الأجهزة الأمنية الأردنية على ضبط الداخل، إلا أن السيناريوهات تشمل احتمال تدفق اللاجئين، أو محاولات تسلل مسلحين، أو ضغوط سياسية داخلية متصاعدة. من ناحية أخرى، يرى صناّع القرار في عمان أن أي ضم محتمل للضفة سيُعيد طرح فرضيات قديمة مفادها أن «الأردن هو فلسطين» وهو ما يرفضه الأردن رفضًا قاطعًا. فالمعطى الديموغرافي وحده، كما يشير تقرير «كوينسي» الأمني، ينذر بأزمة إذا تدفق ملايين فلسطينيين (من حملة الجواز الأردني أو اللاجئين) إلى المملكة. وفي هذا الإطار، يعدّ الخبراء والمحللين أن القضية الفلسطينية مرتبطة عضويًا بالأمن القومي الأردني؛ إذ إن الأردن تحتضن نحو 2.5 مليون فلسطيني مسجلين، وتتشارك مع الضفة موارد مهمة (مياه، مصدّات للطاقة) قد تُستهدف في أي تمهيد لضمّ الأغوار.يمكن تحليل مصادر التهديد بالنسبة للأردن حسب ما يلي:• الهبات الديموغرافية المحتملة: وهو تهديد قيد الطوارئ؛ فقد نقل بعضهم تقارير عن تحركات فلسطينيين في الخارج لشراء عقارات في الأردن تحسبًا لسيناريوات نزوح. • الضغوط الاقتصادية: أشار المحللون إلى أن وضع الأردن المالي وهشاشته النسبية تحُولان دون تحمل مزيد من الأعباء. أي تصعيد في الضفة يعني كلفة إضافية على الأردن (لاجئون، مساعدات، بطالة، استنزاف بنية تحتية). هذا يُضعف قدرة الدولة على التكيف مع أزمات اقتصادية قائمة أصلاً (مياه، طاقة، ديون).• الضغوط السياسية والدبلوماسية: يعمل الأردن على توسيع أجندته السياسية خارح إطار فلسطين، لكن الصداقات الدولية لا تزال غير مستقرة. وعلى الرغم من أن الموقف الأردني الراهن في المحافل الدولية قوي حول غزة والموقف الفلسطيني، لكن ذلك لا يعني ضمناً دعمًا عسكرياً؛ وعلى العكس، لا يملك الأردن حلفاء “قادرين” فعليًا على درء هذا التهديد الاسرائيلي.• انهيار السلطة الفلسطينية/الفراغ الأمني: ضعف السلطة أو انهيارها تحت ضغط الضم أو فقدان الشرعية الشعبية قد يخلق فراغًا أمنيًا في الضفة، هذا الفراغ إمّا تملؤه الفصائل المسلحة أو ميليشيات غير منضبطة، ما يعني انتقال المواجهة مباشرة إلى حدود الأردن، الأردن عندها سيُضطر للتدخل أو مواجهة تبعات الانفلات الأمني.• تصاعد نفوذ الفاعلين غير الدوليين (حماس–الجهاد–فصائل إقليمية مدعومة من إيران): أي توسع لحماس أو دخول فواعل إقليمية على خط الضفة سيُعقّد المشهد الأمني، هذا يضع الأردن بين ضغطين: ضغط شعبي يطالب بدعم المقاومة، وضغط دولي يطالبه بكبحها. ستكون النتيجة: تهديد مزدوج للأمن الداخلي الأردني متمثلة باحتجاجات أو اختراقات أمنية.• انكشاف معاهدة وادي عربة والضغط الدولي: استمرار الضمّ الإسرائيلي يُضعف قيمة المعاهدة أمام الرأي العام الأردني، ويفرض على الأردن خيارات صعبة: إما مواجهة داخلية مع شعبه، أو مواجهة خارجية مع شركائه الغربيين إذا فكّر بتجميد المعاهدة. هذا تهديد سياسي–دبلوماسي لكنه يتحول إلى تهديد داخلي إذا استُخدم كورقة ضغط شعبية.باختصار، الضم سيقلب حسابات الأردن الاستراتيجية رأساً على عقب، ويهدد معاهدة السلام نفسها.السلوك الاستراتيجي الإسرائيليالسياسة الإسرائيلية تعكس مزيجاً من الأيديولوجيا والحسابات البراغماتية. فالقادة الحاليون – حتى العلمانيون منهم – يتحدثون عن "أرض إسرائيل التاريخية" ككيان لا يتجزأ. وقد صرّح نتنياهو في 2025 أنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، مؤكداً رؤيته لـ "إسرائيل الكبرى".هذا التوجه مدعوم بالتحالفات اليمينية داخل الكنيست والعلاقة مع التيارات الإنجيلية الأميركية، خصوصاً مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض وما رافقها من تساهل أميركي مع الاستيطان. عملياً، تحوّل تركيز إسرائيل إلى تكريس "الأمر الواقع" على الأرض بدلاً من أي مسار تفاوضي، ما يرسخ ذهنية "حل الدولة الواحدة" وفق المنظور الإسرائيلي.تستند سياسة التصعيد التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية إلى أربعة دوافع استراتيجية رئيسية:1. اعتبارات أمنية بعد هجوم 7 أكتوبر: في أعقاب هجوم حماس في عام 2023 تسعى إسرائيل إلى منع فتح جبهة ثانية في الضفة الغربية. ورغم أن هذه الإجراءات تُقدَّم في الخطاب الرسمي الإسرائيلي على أنها جزء من استراتيجية "مكافحة الإرهاب الوقائي"، فإن حجم القوة المستخدمة فيها يُضعف السلطة الفلسطينية ويعزز بيئات التطرف – وهي معادلة تثير قلقا بالغا في الأردن.2. أجندة أيديولوجية لليمين المتطرف: تضم الحكومة الإسرائيلية الحالية شخصيات يمينية متطرفة تتبنى رؤية أيديولوجية تقوم على فرض السيادة اليهودية الكاملة على الضفة الغربية، مثل بن غفير. وتُنفذ هذه السياسات دون أي اعتبار للمصالح الأردنية، بل تُعيد إلى الواجهة سرديات خطرة مثل "الأردن هو فلسطين"، والتي يرفضها الأردن بشدة.3. البقاء السياسي الداخلي: يعتمد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعم شركائه في الائتلاف اليميني المتشدد لضمان بقائه في السلطة. ولهذا السبب، يسمح بتطبيق سياسات متطرفة، خصوصا في أعقاب الحوادث الأمنية، لتأمين غطاء سياسي داخلي.4. الشعور بالإفلات من العقاب إقليميا ودوليا: تتصرف إسرائيل انطلاقا من قناعة بأنها تتمتع بهامش واسع من المناورة دون تبعات تُذكر، بسبب تراجع الحضور العربي التقليدي في القضية الفلسطينية، واستمرار الدعم الأميركي، بغض النظر عن بعض الانتقادات الخطابية.من الناحية الأمنية، يمكن قراءة الدوافع الاسرائيلية على النحو التالي:1. أمن استراتيجي/عمق جغرافي: تقديرات خبراء الأمن ترى أن السيطرة على غور الأردن تمنح إسرائيل مواقع رصد وسيطرة استراتيجية (مرتفعات وممرات) تقلل من تعرضها لتهديدات برية مستقبلية؛ هو مبرر تقليدي تتبناه الدوائر العسكرية والأمنية. (منظور واقعي: الدولة تسعى لتعظيم أمنها عبر السيطرة المكانية).2. الضغط الداخلي/السياسة المحلية: التحالفات الداخلية في إسرائيل تميل نحو أحزاب قومية دينية تدفع لضمّ أراضٍ كإنجاز سياسي ولبناء قاعدة انتخابية. تحليلات متعددة لاحظت تزايد النبرة الضمّية بعد 2023 وارتباطها بتبدلات سياسية داخلية.3. السيطرة على الموارد والحدود: غور الأردن يملك موارد مائية وزراعية مهمة؛ ضمّه يتيح لإسرائيل إدارة هذه الموارد بطريقة تخدم سياساتها الديموغرافية — تقليل قدرة الفلسطينيين على البقاء في مناطق حسّاسة. تقارير الاتحاد الأوروبي ترصد تسارعًا في تحويل الصلاحيات الإدارية وتوسيع المستوطنات خلال 2024.إن الأوساط الصهيونية الحاكمة (وداعميها الأميركيين الإنجيليين) باتت تقول بصراحة إن الأرض الموعودة تتجاوز الضفة إلى ما وراءها. هذا التوجّه السياسي يسوّغه رجال السياسة الإسرائيليون الجدد بنظرة “خلاصية” للعقيدة؛ خاصة أن اليمين الديني الصهيوني الحاضر اليوم يخلط بين القومية والدين بحيث يرى خصومه “ضحية” لا شريكاً، ويُنتج نظريةً معقدة لا تقبل الآخر. ويبدو أن هذه البيئة الحاضنة سمحت لصادرات الفكر المتطرف بالعبور إلى الأوساط الأميركية أيضاً، فقد استشهد المحلّلون بتصريحات لمسؤولين أميركيين وبتصريحات سفراء وصحافيين يعكسون عزمًا على محو أي ذكر للقضية الفلسطينية؛ إذ قال أحدهم إن واشنطن تصرّ على “إعادة صياغة المناهج الفلسطينية وإلغاء كل ما له علاقة بالحق الفلسطيني من نكبة وذاكرة وتاريخ”، وهو ما ينبض بنفس السردية التي تطالب بها اليمين الإسرائيلي المتطرف. وفي خضّم هذه الأيديولوجيا، تعزّزت مكانة قادة الكابينة (نفتالي بينيت، أيالِت شاكيد، بن غفير) وحلفائهم، بحيث أصبحت غالبية الإسرائيليين مستعدّة لقبول إجراءات قاسية، كما تظهر استطلاعات رأي عبّرت عن دعم شعبي واسع لسياسات إقحام غزة؛ فقد ذكر الدبعي نتائج استفتاء في الجامعة العبرية تفيد بأن 64% من الإسرائيليين يرون “لا أبرياء في غزة” و52% يوافقون على “ترحيل السكان” من القطاع. السيناريوهات المستقبلية وردود الفعل المتوقعة• السيناريو الأول: الضم التدريجي المستمريرجّح أن تواصل إسرائيل اتباع سياسة الضم الفعلي على مراحل، من خلال فرض سيطرتها الإدارية على مناطق محددة في غور الأردن وأجزاء من المنطقة (C)، عبر قرارات حكومية وإجراءات ميدانية تدريجية. يترافق هذا المسار مع توسيع الاستيطان، وتعزيز الحماية العسكرية، ونقل صلاحيات مدنية تدريجياً إلى السلطات الإسرائيلية. المجتمع الدولي في هذا السيناريو يكتفي عادةً ببيانات إدانة أو مواقف رمزية، دون فرض عقوبات رادعة.الآثار: على الأردن، قد يتسبب هذا السيناريو بضغط لجوء متدرج لكنه مستمر، مع تصاعد التوتر الداخلي والمطالب الشعبية بقطع العلاقات مع إسرائيل. أما فلسطين، فستشهد تراجعاً في قدرة السلطة على إدارة المناطق المصنفة (C) مع تصاعد المقاومة الشعبية وعمليات متفرقة.ردود الفعل العملية: الأردن سيعمد إلى تفعيل خطط استقبال طارئة وإطلاق حملات دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، مع احتمال استخدام أدوات اقتصادية محدودة للضغط. فلسطين قد تتجه إلى تقليص التنسيق الأمني تدريجياً وربط ذلك بتحركات دولية، مع تعزيز مسارات المقاومة المدنية والدعاوى القانونية الدولية.• السيناريو الثاني: الاحتواء الدولي وتجميد مسار الضميُحتمل أن تنجح الضغوط الأوروبية والدولية في رفع كلفة الضم على إسرائيل، عبر إجراءات اقتصادية وقانونية مثل حظر منتجات المستوطنات أو فرض قيود على التعاون الأكاديمي والتقني. هذه الخطوات قد تؤدي إلى تجميد مسار الضم وتحويله إلى صراع سياسي منخفض الحدة بدلاً من فرض وقائع جديدة على الأرض.الآثار: على الأردن، يوفر هذا السيناريو مساحة دبلوماسية أكبر ويعزز دوره كوسيط إقليمي. أما فلسطين، فتتاح لها فرصة لاستعادة جزء من الشرعية السياسية وإحياء مسارات تفاوضية محدودة.ردود الفعل العملية: الأردن يقود تنسيقاً عربياً–أوروبياً لتوسيع نطاق العقوبات المستهدفة، ويعمل على ضمان رقابة دولية على الإجراءات الإسرائيلية. فلسطين تستغل التجميد لتعزيز مطالب الاعتراف الدولي ودفع ملفاتها القانونية قُدماً.• السيناريو الثالث: الانسداد الأمني والانفجار الداخلييتصور هذا السيناريو أن تؤدي خطوات إسرائيلية أحادية سريعة أو متلاحقة إلى انهيار قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة مناطق واسعة، ما يفضي إلى فراغ أمني تتحول فيه المقاومة الشعبية إلى عمليات مسلحة منظمة، مدعومة جزئياً من أطراف إقليمية.الآثار: على الأردن، قد يترتب موجات لجوء واسعة تهدد الاستقرار الداخلي وتضعف قدرات البنية التحتية والأمن. أما فلسطين، فتدخل في دوامة عنف وتشظٍ سياسي يفقدها فرص بناء دولة منظمة.ردود الفعل العملية: الأردن يفعّل خطط طوارئ وطنية على نطاق واسع، يطلب دعماً دولياً عاجلاً، ويعزز أمن الحدود مع فرض ضوابط مشددة على الدخول. فلسطين تُعلن حالة طوارئ وطنية، وتدعو إلى اجتماع هيئاتها القيادية لمواجهة الانهيار وتنظيم المقاومة بهدف منع انزلاقها إلى صراع إقليمي مفتوح.• السيناريو الرابع: حل سياسي إقليمي متدرجيستند هذا السيناريو إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم إقليمي–دولي يجمّد الضم مقابل ضمانات أمنية لإسرائيل وحوافز اقتصادية للضفة الغربية. قد يتجسد ذلك عبر مشاريع تنموية مشتركة مع الأردن وتمويل دولي، بما يفضي إلى تحسين نسبي في الظروف المدنية للفلسطينيين ضمن إطار مؤقت.الآثار: على الأردن، يتيح هذا السيناريو الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وفتح فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز دوره الإقليمي. أما فلسطين، فيمنحها فرصة لإبقاء أفق الدولة مفتوحاً، ولو في صيغة مؤقتة، مع الحاجة إلى ضمانات دولية لصلاحياتها المدنية.ردود الفعل العملية: الأردن يستثمر موقعه لإطلاق مبادرة دبلوماسية واقتصادية تضمن عدم إحداث تغييرات ديموغرافية قسرية، مع الدعوة إلى آليات إشراف دولية. فلسطين تتعامل مع الترتيبات بحذر لتعزيز شرعية مؤسساتها وخلق مساحة سياسية أوسع.مؤشرات الإنذار المبكر• تشريعات إسرائيلية جديدة تتعلق بالأراضي، تُعد مؤشراً على تغيّر السيادة.• ارتفاع وتيرة الإخلاءات القسرية أو أوامر الهدم في غور الأردن، كإشارة مبكرة على موجات نزوح.• قرارات برلمانية أوروبية أو مبادرات قانونية تستهدف المستوطنات، مؤشراً على احتمال تحوّل نحو الاحتواء الدولي.• تصاعد مفاجئ في الهجمات المسلحة داخل الضفة، مؤشراً على احتمالية الانفجار الأمني.• مشاورات رفيعة المستوى بين الأردن وإسرائيل تتعلق بضمانات أو حزم اقتصادية، مؤشراً على احتمال انطلاق مسار تسوية إقليمي.التوصيات الاستراتيجيةأولاً: على المستوى الفلسطيني• إعادة بناء الوحدة الوطنية: أولوية قصوى تتمثل في إنهاء الانقسام السياسي الذي يُضعف الموقف الفلسطيني أمام إسرائيل والعالم. المطلوب مسار حوار وطني شامل يقود إلى انتخابات عامة (تشريعية ورئاسية ووطنية) تُعيد الشرعية للمؤسسات. وينبغي أن يترافق ذلك مع ميثاق سياسي جديد يُحدد أهداف الحركة الوطنية بوضوح ويربطها بحق تقرير المصير ضمن استراتيجية تفاوضية–مقاوِمة متوازنة.• تعزيز المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني: السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إصلاحات جذرية تشمل مكافحة الفساد، تطوير الكفاءة البيروقراطية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد. إلى جانب ذلك، يجب إحياء مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والقطاع الخاص كدعائم للاستقرار الاجتماعي والصمود، وإعطاء مساحة للإعلام الحر والجامعات لتعزيز التماسك الداخلي.• إعادة صياغة التنسيق الأمني: بدلاً من أن يبقى التنسيق الأمني أداة لإدامة الوضع القائم، يمكن إعادة صياغته ليصبح مشروطاً ومحدوداً زمنياً، بحيث يُوقف تلقائياً عند أي خرق جوهري من قبل إسرائيل أو خطوة نحو الضم. وفي موازاة ذلك، يجب تطوير بدائل بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة لتأمين الخدمات الأساسية ومنع الانهيار المؤسسي.ثانياً: على المستوى الأردني• التمسك بالوصاية والدور الإقليمي: يتعين على الأردن أن يربط بقاء معاهدة السلام واستمرار التعاون مع إسرائيل باحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات، ورفض أي ضم رسمي. هذا الدور يضيف بعداً شرعياً لموقف الأردن ويجعله لاعباً لا غنى عنه في أي معادلة مستقبلية.• تعزيز التحالفات الإقليمية: المطلوب بناء شبكة تفاهمات مع مصر والعراق ودول الخليج، وربط مسار التطبيع العربي بإسرائيل بمدى احترامها لالتزاماتها القانونية ووقف الضم. يمكن للأردن أن يقترح مبادرة عربية–أوروبية مشتركة لمراقبة الوضع الميداني وفرض ضغوط سياسية واقتصادية متدرجة.• تحصين الجبهة الداخلية: داخلياً، يجب صياغة خطاب وطني يوحد الأردنيين حول اعتبار استقرار الضفة جزءاً من الأمن القومي الأردني. المطلوب حملة تواصلية شاملة (سياسية، إعلامية، تعليمية) تشرح للمجتمع أن مواجهة الضم ليست مسألة تضامن خارجي فقط، بل شرطاً لحماية الاستقرار والديموغرافيا في الأردن ذاته.• إدارة المخاطر والسيناريوهات: على الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة تطوير خطط محاكاة لمختلف السيناريوهات، من تهجير محدود إلى انهيار شامل للسلطة. ويتضمن ذلك تعزيز الدفاع المدني، تجهيز مخيمات طوارئ، وضع خطط اقتصادية بديلة، والتنسيق مع شركاء دوليين لتمويل الاستجابة الإنسانية.ثالثاً: على المستوى الدولي• تعظيم الضغوط القانونية والدبلوماسية: الاستيطان والضم يجب أن يُعاد تعريفهما كجرائم دولية، مع تفعيل المسارات أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. على الأردن وفلسطين الدفع باتجاه قرارات جديدة في الأمم المتحدة وتصعيد الحملة الدبلوماسية التي تفضح الطابع غير القانوني للاستيطان.• بناء تحالفات ضغط مع أوروبا: الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات اقتصادية وقانونية يمكن أن ترفع كلفة الضم على إسرائيل (منع استيراد منتجات المستوطنات، تقييد التعاون الأكاديمي والتكنولوجي، فرض عقوبات محددة على شركات داعمة للاستيطان). يجب تحويل هذه الإجراءات من مبادرات رمزية إلى سياسة متماسكة تُجمّد الضم وتمنع تكريسه.• تعبئة الرأي العام الدولي: عبر حملات إعلامية ومؤتمرات أكاديمية وقانونية، يمكن للأردن والفلسطينيين خلق سردية مضادة تضع إسرائيل في خانة خرق القانون الدولي، وتُعيد الاعتبار لحل الدولتين كخيار وحيد يحظى بشرعية دولية.رابعاً: آليات تنسيق مشتركة أردنية–فلسطينية• غرفة عمليات استخباراتية مشتركة: بإشراف دولي، يمكن إنشاء مركز معلومات أردني–فلسطيني لتبادل البيانات الاستخباراتية SIGINT وOSINT حول أنشطة المستوطنين والتحركات العسكرية، بهدف توقع موجات النزوح والتعامل معها مبكراً. • هيئة طوارئ إقليمية: تضم الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية بمشاركة مراقبين دوليين، لتنسيق الاستجابة الإنسانية والأمنية عند أي انهيار ميداني.• منصّة إنذار مبكر: لرصد التشريعات الإسرائيلية الجديدة، عمليات الإخلاء القسري، التحركات العسكرية، والقرارات الأوروبية، بما يمكّن من اتخاذ قرارات استباقية على المستويين الأردني والفلسطيني.خامساً: أبعاد استراتيجية بعيدة المدى• إعادة تعريف الصمود: بدلاً من النظر إلى الصمود كحالة إنسانية مؤقتة، يجب تحويله إلى مشروع سياسي–اقتصادي طويل المدى، عبر الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية الفلسطينية، بتمويل إقليمي ودولي.• التوازن بين الواقعية والشرعية: الأردن مضطر للموازنة بين التزاماته الدولية والتحالفات الغربية من جهة، ومتطلبات شرعيته الداخلية وعمقه الفلسطيني من جهة أخرى. أفضل صيغة هي لعب دور "الداعم السياسي–القانوني–الاقتصادي للصمود الفلسطيني" مع الحفاظ على قنوات أمنية غير معلنة لتفادي الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.الضمّ المحتمل ليس حدثًا يمكن تجاهله أو إدارة آثاره بشكل إفرادي. الاستراتيجية الأكثر واقعية وفاعلية لصناع القرار الأردني والفلسطيني تتمثل في مزيج متوازن من الحفاظ على الأمن الداخلي، والتحرك الدبلوماسي والقانوني الدولي لرفع الكلفة على إسرائيل، وبناء تحالفات إقليمية ذات مصداقية. إن الوضع الراهن يتطلّب تنسيقًا فوريًا وموحدًا؛ ففرص الحدّ من الضمّ أو تخفيف آثاره تكمن في رفع الكلفة السياسية والدبلوماسية للأفعال الإسرائيلية، إلى جانب استعداد أمني مدروس للحدّ من الكوارث الإنسانية المحتملة.ورقة تقدير موقف: الضم سيقلب حسابات الأردن الاستراتيجية رأساً على عقب ويهدد معاهدة السلام نفسها

مدار الساعة ـ