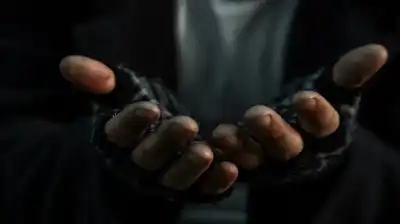التاريخ ليس كتابًا يُقرأ من الورق، بل قوة حية تسكن الجغرافيا وتتحكم بمصائر الأمم. في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع الأديان والإمبراطوريات والحروب، تصبح فلسفة التاريخ حاضرة باستمرار. من يقرأ فلسفة التاريخ لا ينظر إلى الأحداث بوصفها مجرد تواريخ ومعاهدات، بل كجزء من مسار طويل تحكمه قوانين وتطورات. هذا ما أدركه ابن خلدون حين شبّه الدول بالكائنات الحية، تولد، وتقوى، ثم تهرم وتنهار. وما رآه هيغل حين قال إن التاريخ هو مسيرة الروح نحو الحرية. وبينهما، صاغ شبنغلر نبوءة قاتمة عن أفول الحضارات، فيما فتح توينبي نافذة للأمل حين كتب عبارته الشهيرة "الحضارة تنشأ من استجابة خلاقة للتحدي".
هذه العبارة التوينيّة تكاد تختصر قصة الأردن، دولة صغيرة بالمساحة، ومحدودة الموارد، نجت من عواصف لا تُحصى، لكنها وجدت في الاستجابة الخلاقة سبيلًا للبقاء، بل وللعب دور يفوق حجمها الجغرافي والاقتصادي في قلب جغرافيا النار. الا ان الأردن اليوم يقف اليوم مجددًا على عتبة سؤال فلسفي استراتيجي، هل السلام مع إسرائيل محطة للاستقرار، أم استراحة قصيرة في رحلة صراع أطول تحكمها قوانين التاريخ؟الشرق الأوسط ليس ساحة محلية، بل هو قلب العالم التاريخي، الذي تتناوب عليه القوى. منبع الرسالات، ملتقى الإمبراطوريات، ومركز الصراع على النظام العالمي. في لحظة ما بعد الحرب الباردة، كان يُعتقد أن الوصول الى اتفاقيات سلام في الشرق الأوسط، فإنها لا تكون مجرد وثائق سياسية، بل هي مرحلة لإعادة توجيه مسار التاريخ نفسه. السلام قد يفتح صفحة جديدة، فكانت أوسلو 1993، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكانت وعدًا بدولة فلسطينية مؤجلة، وهي تجسيدًا لفكرة هيغلية بأن التاريخ يسير نحو "الاعتراف المتبادل" كخطوة نحو الحرية. لكنها بقيت سلامًا مؤجلاً، إذ لم تُترجم إلى دولة فلسطينية مستقلة، مما جعلها أقرب إلى تسوية ظرفية، وتحولت إلى سلام ناقص، بل الى محاولة تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، مما أفرز خيبة أمل تاريخية وليس نقطة تحول في التاريخ.ثم جاءت اتفاقية وادي عربة 1994، بين الأردن وإسرائيل، فقد كانت بالنسبة للأردن أكثر من ورقة سياسية، فقد أراد الأردن أن يحمي نفسه من الاضطرابات الإقليمية عبر تسوية قانونية ودبلوماسية لملفات الحدود والمياه والأمن، وان يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وامن واستقرار وازدهار المنطقة، وتكون بذلك حملة فلسفة مختلفة عن فلسفة أوسلو، وجاءت وكأنها اسقاط لمنظور ابن خلدون، انها مثلت استجابة سياسية لحماية العمران والدولة في وجه تهديدات الفوضى والحروب، وليس استسلاماً، كما تحدث البعض، بل كانت محاولة لتثبيت الأمن الوطني، واستجابة خلاقة للتحدي، منحت الأردن استقرارًا حدوديًا ومائيًا، وأتاحت له هامش مناورة في لحظة شديدة الاضطراب.اليوم وبعد ثلاثة عقود، يتبين بان اتفاقيات أوسلو 1993، ووادي عربة 1994، لا بل ويضاف اليها اتفاقية كامب ديفيد 1978، لم تكن سوى محطات في صراع أطول. يعود ذلك الى ثلاثة أسباب، أولها، صعود اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي ينظر إلى الاتفاقيات كإجراءات تكتيكية لا التزامات استراتيجية، مما يقوض فلسفة السلام الدائم، وثانيها، تآكل الشرعية الشعبية للاتفاقيات، سواء في فلسطين أو الأردن، ومصر، حيث ترى الشعوب أن إسرائيل لم تلتزم بجوهر الاتفاقيات (القدس، واللاجئين، والدولة الفلسطينية)، لا بل اصبح واضحاً للجميع بان إسرائيل تعمل بكل طاقتها لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، وثالثها، التحولات الدولية المتسارعة، مع صعود قوى عالمية جديدة في وجه الهيمنة الأمريكية. مما قد تفقد هذه الاتفاقيات والتي صُممت لضمان استقرار المنطقة، دعم المظلة الدولية التي حمتها سابقاً، مما يكشف هشاشتها البنيوية.اليوم في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وما يشهده من إبادة جماعية موثقة وشبه معلنة، وفي ظل التهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية، يجد الأردن نفسه أمام معادلة تاريخية معقّدة تجاه اتفاقية السلام الموقعة عام 1994. فالأردن، الذي لطالما اعتبر نفسه المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ووصياً على المقدسات في القدس، بات يرى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوّض الأساس الذي قامت عليه معاهدة وادي عربة. وجاءت قضية منع الوفد الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة (حيث سيتم مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية) لتزيد من قتامة المشهد، وهو الامر الذي يعتبر دليلاً إضافياً على اختلال موازين العدالة الدولية، وتواطؤ بعض القوى الكبرى في تحييد وابعاد الشريك الفلسطيني. وفي ضوء هذه التطورات، يبرز الموقف الأردني أكثر تمسكاً بأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ووقف سياسات الإبادة والتهجير التي تهدد أمن المنطقة برمتها، وتهدد الفلسفة التي قامت عليها اتفاقية وادي عربه.من منظور فلسفة التاريخ، كل اتفاقية سلام هي عبارة عن كائن حي، تولد، وتزدهر، ثم تواجه تهديدات البقاء، واتفاقية وادي عربة ليست استثناء منها. لكن التاريخ لا يتوقف، التطرف المتصاعد في إسرائيل، وتآكل الشرعية الشعبية للاتفاقيات، وتغير موازين القوى الدولية، كلها تهدد استمرارية وادي عربة. هنا يبدو ان اتفاقية وادي عربه تواجه سيناريوهات محدودة، منها سيناريو الاستمرار، بحيث تبقى الاتفاقية قائمة، لكنها تتعرض لاهتزازات دورية، ويستفيد الأردن منها كورقة ضغط دبلوماسية وإطار قانوني لضمان أمنه المائي والحدودي، وسيناريو الانهيار، في حال أقدمت إسرائيل على خطوات تهدد الأمن القومي الأردني (مثل ضم الضفة الغربية أو المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات)، فإن إلغاء الاتفاقية قد يصبح خيارًا مطروحًا، لكن ذلك سيحمل معه تهديدات جدية، منها، توتر أمني وعسكري على الحدود الأطول مع إسرائيل، وتصاعد التهديدات الداخلية نتيجة غياب المظلة القانونية للعلاقة، وتعقيدات اقتصادية، خاصة في ملفي المياه والطاقة.السؤال الفلسفي اليوم، هل تبقى الاتفاقية إطارًا هشًا يضمن الحد الأدنى من الاستقرار؟ أم تسقط، فتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تعيد صياغة موقع الأردن ودوره؟الأردن يقف عند مفترق طرق دقيق. إلغاء الاتفاقية يعني عودة الحدود الأطول مع إسرائيل إلى حالة "اللا إطار". سياسياً، قد يكسب الأردن شرعية شعبية وإقليمية، لكن استراتيجيًا سيدخل في مواجهة مفتوحة تحمل مخاطر حدودية، وأمنية، ومائية واقتصادية.المعادلة هنا، ليست أردنية إسرائيلية فقط، فالانهيار ان حدث، سيستدعي القوى الكبرى. الولايات المتحدة ستقاتل للحفاظ على الاتفاقية، لأنها جزء من بنية الأمن الإسرائيلي، وانهيارها يُقرأ في واشنطن كهزيمة استراتيجية. بينما الاتحاد الأوروبي قد يدعم الأردن سياسيًا واقتصاديًا، لكنه يفتقر إلى أدوات النفوذ المباشر على إسرائيل. بينما روسيا سترى الفراغ فرصة لتوسيع نفوذها وتقديم نفسها كوسيط بديل، خاصة بعد تجربتها في سوريا. اما الصين، ببراغماتيتها، ستتعامل مع الأمر من زاوية الحزام والطريق، وستدعم الاستقرار الأردني لضمان مصالحها التجارية والطاقة.في هذا المشهد، يصبح الأردن أكثر من مجرد طرف في معاهدة، يصبح محورًا في معادلة إعادة توزيع النفوذ العالمي في الشرق الأوسط.في مثل هذا الحالة، يبرز دور الملك، باعتباره الضامن الأعلى للمصالح الوطنية، حيث ان فلسفته في إدارة الأزمات تقوم على ثلاثة محاور، الأول، حماية المصالح الوطنية العليا عبر إعادة صياغة التحالفات الإقليمية والدولية، وبما يمنح الأردن شبكة دعم جديدة ويحول دون عزله، والثاني، منع الاهتزازات الداخلية من خلال تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وإطلاق خطاب وطني جامع يكرس الاصطفاف خلف القيادة في مواجهة التحديات، والثالث، البحث عن الية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر إيجاد بدائل سريعة للمياه والطاقة والاستثمارات، لتفادي أي انعكاس مباشر على حياة المواطنين.هنا تتحول القيادة إلى ما يسميه المؤرخون بالقيادة الضامنة، قيادة قادرة على تحويل التهديد الخارجي إلى فرصة لتعزيز التماسك الداخلي وبناء مشروع وطني جامع.إذا كانت فلسفة التاريخ تعلمنا أن الاتفاقيات والسلامات ليست نهاية المطاف، فإن وادي عربة ليست سوى محطة في مسيرة أطول. إلغاء الاتفاقية سيضع الأردن في موقع أكثر مواجهة، لكنه قد يعزز من شرعيته الشعبية والإقليمية. وهنا يظهر البعد لفلسفة توينبي بالغ الأهمية، ويصبح السؤال ليس هل تنهار الاتفاقية أو تصمد؟ بل كيف يستجيب الأردن للتحدي؟ وهل سيكون الإلغاء استجابة خلاقة تعزز سيادة الأردن ودوره الإقليمي، أم أنه انزلاق نحو تحديات أكبر تهدد امنه الاستراتيجي وتحد من قدرته على التحمل؟اليوم، نجد ان الشرق الأوسط مقبل على دورة جديدة من التاريخ. الغرب يشيخ، الشرق يصعد، وإسرائيل تغرق في تطرفها. وسط كل ذلك، يبقى الأردن أمام معادلة صعبة، الحفاظ على الاتفاقية كإطار دفاعي مع إسرائيل، مقابل التمسك بحقوقه الاستراتيجية والتاريخية في القدس وفلسطين. وهذا التوازن هو ما سيحدد مستقبل وادي عربة، ليس كوثيقة سلام فقط، بل كجزء من فلسفة الأردن في صراعه المستمر في جغرافيا تتصارع عليها الأمم وتعصف بها الاحداث. وعلينا ان نتذكر بان التاريخ لا ينتظر المترددين، بل يكافئ من يحسن قراءة لحظاته الحرجة، فالحضارة لا تموت حين تواجه التحديات، بل حين تعجز عن الاستجابة لها (توينبي).الا اننا نؤمن بان الأردن سيكون حالة استثنائية، دولة صغيرة بحجمها، لكنها بحكمتها وشرعيتها التاريخية، بقيادته ووعيه الجمعي، ما زال يملك القدرة على أن يكون الاستجابة الخلاقة في زمن يفيض بالانهيارات.دراسة لحزب عزم الأردني: حين يتكلم التاريخ...معاهدة السلام على المحك

مدار الساعة ـ