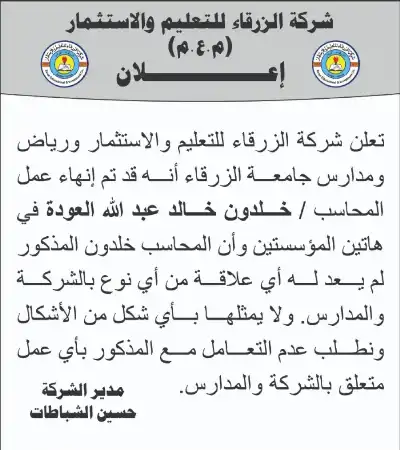مدار الساعة - أصدر معهد السياسة والمجتمع، اليوم الاثنين، دراسة جديدة ضمن مشروعه الذي يستهدف العمل السياسي داخل الجامعات الأردنية "جيل التحديث"، تسلّط الضوء على العمل الطلابي في الجامعات الأردنية بوصفه رافعة أساسية لمسار التحول الديمقراطي والتحديث السياسي. الدراسة، التي وُصفت بأنها من الأوسع منهجيا في الأردن خلال الأعوام الأخيرة، تمزج بين التحليل التاريخي والمقارن والعمل الميداني، وتعتمد على تسع مجموعات تركيز مع طلبة من تسع جامعات، واستبيان شمل 896 طالبا وطالبة من ثماني جامعات، إلى جانب مقابلات معمّقة مع خبراء ومسؤولين في التعليم العالي والأحزاب السياسية. وقاد الفريق البحثي المستشار الأكاديمي للمعهد ووزير الشباب الأسبق الدكتور محمد أبو رمان، بمشاركة الباحثين محمد الأمين عساف وعمر أبو عنزة.
من الحركات العالمية إلى التجارب المحلية: قراءة تاريخية في تطور العمل الطلابيتنطلق الدراسة من تأصيل تاريخي لمسار الحركات الطلابية عالميا منذ القرن التاسع عشر؛ إذ ترصد تحوّل الطلاب من كتلة اجتماعية متفرقة إلى فاعل سياسي ومجتمعي له أثر مباشر في صوغ السياسات العامة وتحريك الفضاء العام. وتُبرز المقاربات النظرية التي قاربت الظاهرة الطلابية من منظور الهوية والفرص السياسية والتعبئة الاجتماعية، مؤكدة أن الطلبة يتحركون باعتبارهم "هوية اجتماعية" مستقلة وجزءا في الوقت نفسه من المجتمع المدني، ما يمنح العمل الطلابي قدرة متجددة على التأثير حين تتوافر الشروط المؤسسية والقانونية والمالية الداعمة له.
وتُظهر المقارنة بين التجارب الغربية أن الاتحادات الطلابية التي تمتلك أساسا قانونيا واضحا واستقلالية مالية وقدرة تمثيلية ملزمة لقرارات الجامعات، تميل إلى الاستمرارية والتأثير على المدى البعيد، بعكس النماذج التي تُترك بلا سند قانوني فتتحوّل إلى هياكل شكلية أو منصّات خدماتية محدودة الصلاحيات. كما تسجّل الدراسة تحوّلا عالميا لافتا في طبيعة الحراك الطلابي؛ إذ بات التنظيم يتمحور حول قضايا محددة أكثر من الارتباط بإطارات أيديولوجية كبرى، وباتت التحالفات تتشكّل سريعا حول مطالب ملموسة وتتلاشى بالسرعة نفسها، غير أنّ "ذاكرة" هذا الحراك وثقافته المتراكمة تظل رأس المال الأهم، لأنها تهيّئ الأرضية لتجارب لاحقة وتزوّد المجتمع بخبرة احتجاجية ومعرفية قابلة لإعادة التفعيل.الواقع الأردني: ضعف الاستقلال المؤسسي يقيّد فعالية اتحادات الطلبةعلى هذه الخلفية، تنتقل الدراسة إلى تشخيص المشهد الأردني على مستويين: البنية المؤسسية والقانونية من جهة، والحياة الطلابية وموازين القوى من جهة أخرى. وتخلص إلى أن الجامعات الأردنية تفتقر إلى استقلالية مؤسسية فعلية عن وزارة التعليم العالي، وأن اتحادات الطلبة تظل في أغلب الأحيان تابعة لعمادات شؤون الطلبة بصلاحيات محدودة، ما يقيّد قدرتها على تمثيل الطلبة والتأثير في القرارات الاستراتيجية. هذا الواقع، بحسب الدراسة، قاد إلى تشظّي العمل الطلابي بين انتماءات حزبية وتنافسات جزئية واحتجاجات متفرقة، ووسّع الفجوة بين طموح الطلبة إلى المشاركة وبين السياسات الجامعية، في ظل غياب أطر وطنية جامعة تنظّم العمل الطلابي وتربطه بمسار التحديث السياسي العام.وتؤكد الدراسة أن المسار التاريخي-القانوني للتعليم العالي في الأردن أسّس لجامعة أردنية لعبت دورا محوريا في بناء الدولة الحديثة، ثم شهدت توسعا حكوميا وخاصا أوجد جغرافيا جديدة للتعليم العالي. ومع دخول البلاد في مرحلة "التحديث السياسي"، تبرز الحاجة إلى "استقلال فعلي" للجامعات يتجسّد في آليات تمثيلية داخل مجالس الأمناء تقلّص أثر التعيين المباشر، وفي تحصين المسار الأكاديمي والإداري من التسييس، وتمكين هيئة الاعتماد وتمويل الجامعات بما يوازن بين الكم والنوع، ومواءمة اللوائح الداخلية مع الحقوق الدستورية والحزبية الجديدة. بهذه الحزمة، تعود الجامعة إلى دورها الطبيعي منتِجا للمعرفة، ويعود الطالب إلى مركز الحياة الجامعية فاعلا سياسيا-مدنيا لا متلقيا فقط.تحولات الخريطة الطلابية منذ التسعينيات من القومية واليسار إلى الإسلاميين والعشائر
أحد محاور الدراسة الأكثر إثارة هو تحليل تحولات الخريطة الطلابية منذ التسعينيات. فبعد حضور التيارات القومية واليسارية تاريخيا، انتقل المشهد إلى ثنائية جديدة هي التيار الإسلامي من جهة، والتيارات العشائرية-المناطقية من جهة أخرى. ويبيّن التحليل أن التيار الإسلامي، رغم تعرّجه في محطات الانفتاح والانغلاق، نجح في التكيّف والحفاظ على زخم تنظيمه وخبرته التراكمية، فيما بدت التيارات العشائرية قوية الحضور انتخابيا لكنها هشّة تنظيميا وقابلة للتفكك السريع. كما تسجّل الدراسة أثر هذه الثنائية على ظواهر سلبية كالعنف الجامعي في بعض جامعات الأطراف، مع محاولات متقطّعة لإضفاء طابع برامجـي وطني على هذا الحضور لموازنة الخطاب الإسلامي.على صعيد العلاقة بين التيارات الطلابية والأحزاب، ترصد الدراسة انتقالا تدريجيا من التبعية المباشرة إلى استقلالية نسبية، حتى لدى التيارات القريبة من جبهة العمل الإسلامي، حيث باتت الأطر الطلابية أكثر ارتباطا ببيئتها الجامعية وأقل اشتباكا تنظيميا مباشرا مع الحزب. وتوثّق الدراسة نشاط أحزاب جديدة منذ 2021، غير أنّ هذا النشاط ارتبط في أذهان كثير من الطلبة بممارسات المال الانتخابي أكثر من بناء قواعد طلابية صلبة، ما أضر بصورة العمل الحزبي بدل أن يعزّزها. ومع ذلك، تكشف نتائج الاستبيان تفاوتا بين انطباعات مجموعات التركيز—الأكثر نقدا—وبين عيّنة الاستطلاع التي أبدت نظرة أقل سلبية تجاه الأحزاب والانتخابات الطلابية، بما يفتح نافذة لإعادة بناء الثقة إذا ما توفرت سياسات جديدة أكثر قربا من اهتمامات الطلبة.وتفرد الدراسة مساحة لتوثيق ظاهرة الفضاءات الطلابية المستقلة خارج الأطر التقليدية داخل الجامعة وخارجها؛ من "ديوان فاطمة" الذي تأسس في كلية الهندسة بالجامعة الأردنية ليقدّم منصة نقاش ثقافي وفكري يركّز على إنتاج المعرفة، إلى "مساري" الذي يطوّر معارف ومهارات المشاركين في مجالات اجتماعية وتربوية، مرورا بمشروع "فاستمسك" في جامعة اليرموك، و"المدونة الطلابية" التي توثّق قضايا الحقوق والحريات داخل الجامعات، ووصولا إلى فريق "زووم إن" الذي انتقل من ذراع ذي مرجعية إسلامية إلى فريق مستقلّ بهوية أكثر انفتاحا مع الحفاظ على حدّ أدنى من المرجعية المحافظة. هذه المبادرات، على اختلافها، تعبّر عن تعطّش جيل شابّ إلى مساحات نقاش حرّة، وإلى أطر مرنة قادرة على تجاوز القيود الإدارية وتقديم قيمة معرفية وثقافية وحقوقية ملموسة.تفاوتات جغرافية وثقافية بين الجامعات الأردنية
وتتوقف الدراسة أمام تفاوتات جغرافية واجتماعية وثقافية بين الجامعات؛ فالحراك في الجامعة الأردنية أكثر تنوعا وزخما بحكم تركيبتها الواسعة، بينما يخضع التنافس في جامعات الشمال لمعادلات عشائرية وجغرافية أمتن، وتظهر جامعات الجنوب أكثر تأثرا بهذه الاعتبارات، فيما تعاني الجامعات الخاصة من محدودية واضحة في النشاط والتيارات، وتلجأ بعضُها إلى انتخابات شكلية أو بالتزكية، وهو ما يُضعف ثقافة التمثيل والمساءلة.على مستوى اتحادات الطلبة، تقدم الدراسة تشخيصا بنيويا واضحا: غياب السند القانوني الملزم يجعل هذه الاتحادات أقرب إلى أطر إجرائية تتبع لعمادات شؤون الطلبة، بصلاحيات محدودة وتأثير شكلي في صناعة القرار الجامعي، فضلا عن قيود مالية وبيروقراطية تحدّ من قدرتها على تقديم الخدمات وتعزيز المشاركة. وتلفت إلى أنّ توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية شجّعت الجامعات على دفع المشاركة الطلابية وإجراء الانتخابات، لكن التطبيق ظل متفاوتا؛ إذ امتنعت بعض الجامعات الخاصة عن الانتخابات، فيما قيدت جامعات أخرى العملية بصورة لا تنسجم مع روح التحديث.وتصل الدراسة إلى "مصفوفة أولويات" عملية تستهدف ثلاثة مسارات متوازية. أولا، على صعيد التيارات الطلابية: تسجيل التيارات رسميا ومنحها شرعية واضحة ومساحات عمل أوسع، تكييف النظم الانتخابية نحو القوائم النسبية التي تشجع العمل الجماعي، بناء القدرات القيادية والتنظيمية والتفاوضية، ووضع أنظمة داخلية تساعد على مأسسة الكتل بعيدا عن الشخصنة والولاءات الطارئة. كما تدعو إلى تغيير الثقافة السائدة في تشكّل الكتل نحو المعايير البرامجية والخدماتية—بل والسياسية—بدل حصرها في الاعتبارات العشائرية والمناطقية.ثانيا، في العلاقة بين التيارات الطلابية والأحزاب: تستعرض الدراسة طيفا من النماذج الممكنة من الارتباط المباشر إلى الاستقلال الكامل، وتدعو الأحزاب إلى تبنّي أجندات حقيقية لقضايا الجامعات والطلبة، والعمل بأسلوب قاعدي يبدأ من داخل الحرم الجامعي بدل الاكتفاء بحملات انتخابية موسمية. ويمكن أن تُبنى علاقات غير مباشرة تقوم على التوافق القيمي والبرنامجي، بما يسمح ببروز تيارات طلابية محلية قوية، دون أن تقع في أسر المال الانتخابي أو التبعية التنظيمية المفرطة.ثالثا، في الإدارات الجامعية ودور الحكومة والمجتمع المدني: تقترح الدراسة ربط الأنشطة الطلابية بالعملية التعليمية عبر ساعات خدمة مجتمعية أو احتساب الأنشطة في التقييمات الدراسية، وتوسيع الهامش المتاح لتأسيس الأندية وتشجيع المشاركة من خلال حوافز ملموسة. كما تدعو الوزارات والمؤسسات المعنية—الشؤون السياسية والبرلمانية، والهيئة المستقلة للانتخاب مثلا—إلى برامج توعية أكثر جودة وواقعية، بالشراكة مع الجامعات، لتقليص فجوة المعرفة الحزبية لدى الطلبة، إذ يعترف نحو ثلثي الطلاب بضعف اطلاعهم على برامج الأحزاب.وفي المحصلة، تؤكد الدراسة أن الطلبة يشكّلون محور عملية التحديث السياسي في الأردن، وأن أي تحول ديمقراطي حقيقي يبدأ من الجامعة باعتبارها بيئة التنشئة السياسية والاجتماعية الأولى. من هنا يأتي مشروع "جيل التحديث"، الذي ينفذه المعهد بالشراكة مع السفارة الهولندية في عمّان، ليترجم المعرفة إلى تدخلات عملية في عشر جامعات أردنية، عبر رفع الوعي السياسي وتطوير مهارات الحوار والمشاركة، وبناء فضاءات نقاش ومنصات قيادية لشباب يتطلّع إلى دور عامّ أعمق وأكثر تأثيرا.وتختتم الدراسة بإشارة منهجية لافتة: الحراك الطلابي لا يسير في خطّ تصاعدي أو تنازلي مستقيم، بل يمرّ بموجات مدّ وجزر، ومع ذلك فإن تراكم خبراته وثقافته، ووجود أطر قانونية وتمثيلية ومالية صلبة، كفيل بأن يحوّل الجامعات إلى مختبر ديمقراطي حيّ، ويعيد وصل السياسة بحياة الشباب اليومية على قاعدة المشاركة والمسؤولية والقدرة على التغيير. بهذه الرؤية، لا تبدو الاتحادات والتيارات الطلابية مجرد تفاصيل في المشهد الجامعي، بل حجر زاوية في مشروع وطنيّ أشمل عنوانه: تحديث يضع الطالب في القلب من العملية السياسية.يذكر أن هذه الدراسة تأتي كإحدى المحطات الرئيسية ضمن مشروع «جيل التحديث» الذي ينفّذه معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع السفارة الهولندية في عمّان. الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية لطلبة الجامعات في عشر جامعات أردنية، من خلال مجموعة من التدخلات الهادفة إلى رفع مستوى المعرفة السياسية وتطوير مهارات الحوار والمشاركة لديهم، وذلك انسجامًا مع المسار الوطني للتحديث السياسي المنبثق عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.وتمثّل هذه الدراسة الأساس المعرفي للمشروع، إذ تسعى إلى فهم واقع المشاركة الطلابية في الجامعات الأردنية وقياس توجهات الطلبة، بهدف تحليل طبيعة المشاركة واتجاهاتها وفرصها وتحدّياتها، بما يسهم في وضع تدخلات أكثر فاعلية تستجيب لاحتياجات الشباب الجامعي.